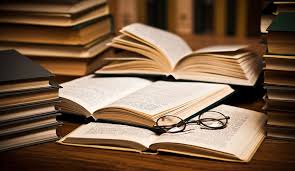ليس بالضرورة أن يكون السياسي أو رجل الدولة كاتبًا أو شاعرًا؛ بيد أنه إذا صار كذلك تميز عن أقرانه بهذه الموهبة وتلك الحرفة؛ فالعلاقة بين الأدب والسياسة إضافة مؤثرة وإن لم تكن في عيار تأثير العلاقة مع التاريخ وعلم الاجتماع. إن الخطابة أحد سبل التأثير في الجماهير؛ لذا حفظت لنا خطب زعماء وقادة ومنشقين ومعارضين، وستبقى الكلمة حاضرة في هذا الميدان الخطر مهما عارض الناس الكلام والخطابة بحجة أنه مجرد كلام، وكأن هذا الاعتراض على هذه الأحاديث سيق بغير كلام من جنس المنتَقد!
وسوف أعرض مؤلفًا عربيًا عن الكتابة للسياسي، وبعده سأعرض -بحول الله- مقالات “جورج أوريل” عن اللغة والسياسة في مقال آخر. عنوان الكتاب العربي: الخطابة السياسية في العصر الحديث، تأليف: د.عماد عبد اللطيف، صدرت طبعته الأولى عن دار العين للنشر عام (1436=2015م)، وعدد صفحاته (187) صفحة مكونة من الإهداء لياسمين، ثم مقدمة وثلاثة فصول، فملحق فيه خطب، ثم قائمة بالمصادر يتلوها تعريف بالمؤلف.
أما المؤلف فهو باحث زائر بجامعة كمبرج، وأستاذ مشارك بجامعة قطر، ودرّس البلاغة وتحليل الخطاب بجامعة القاهرة وجامعة لانكستر، وحاضر في جامعات عربية وأخرى أوربية. أيضًا نشر المؤلف ما يقرب من أربعين بحثًا بالعربية والإنجليزية. كما صدرت له خمسة كتب بالعربية، وشارك في تأليف أحد عشر كتابًا، واختارته مؤسسة ” من يكون” الأمريكية ضمن أهم الشخصيات الأكاديمية في العالم العربي عام (2013م)، ولا غرابة والحال هذه أن نال كاتبنا جوائز عربية ودولية.
يتحدث الفصل الأول عن جمهور الخطابة السياسية من الصحيفة إلى اليوتيوب، ويدرس الفصل الثاني عصر استجابة الجماهير متخذًا من خطاب أوباما للعالم الإسلامي نموذجًا، بينما يسهب الفصل الثالث في موضوع كتّاب الخطب السياسية، ومعضلة الكاتب الخفي، وربما أنه أهم فصول الكتاب لديّ على الأقل. ثم أضاف المؤلف ملحقًا فيه مختارات من خطب سياسية مصرية، وسرد المراجع العربية وعددها خمسة وثلاثون مرجعًا، وعدد الأجنبية على النصف من العربية، وفي القائمتين كتب للدكتور عماد عبداللطيف، وهذا يشير لعنايته بهذا الباب.
ذكر د.عماد في المقدمة أن الخطبة السياسية أداة مثلى للتأثير في الجماهير، ومن وسائل التواصل بين النخب السياسية والشعب. وقال بأن الحاكم لا يلجأ بإلحاف إلى الخطابة السياسية إلا عندما تصبح الشعوب قوة يحسب لها حساب، وأنه كلما زادت الحرية السياسية زاد نشاط الخطب السياسية وتأثيرها، ودلل على ذلك بأحداث على الساحة المصرية عام (1919م)، وعام (2011م). وقد صارت الخطبة السياسية حقلًا معرفيًا في موضوعاتها، ومناسباتها، وطبيعة المتكلم، والجمهور المخاطب، والوسائط المستخدمة، وفي تطور أساليبها، وعملية تأليف الخطب، والعلاقة بين الكاتب الذي يكتبها والسياسي الذي يلقيها. ويمكن أن يزاد على ذلك دراسة أثر تلك الخطب، ومستوى تفاعل الناس معها، والأداء الخطابي للزعيم.
وفي زماننا انتقلت الخطبة السياسية من عصر الجماهير القليلة إلى عصر الجماهير الحاشدة، وأدى تنوع القوى السياسية إلى تنوع الخطب السياسية؛ ولكل قوة سياسية لغتها وخطابتها وبلاغتها ومعجمها الذي تستمد منه المعاني والتراكيب والاستشهادات. وتجاوزت الخطب كونها مجرد أداة إلى أن أصبحت عملًا رئاسيًا من الدرجة الأولى. وتبين للباحث من الاستقراء أن الخطابة السياسية نشاط يتأثر بالحياة السياسية للمجتمع؛ فالمجتمعات جوهرها التنوع، والسياسة جوهرها التنازع، والخطب ساحة عراك بينهما فيما يبدو لي!
كما احتفظت الذاكرة السياسية والتاريخية بخطب وعبارات وكلمات، ولأن الكتاب مقتصر على مصر فالأمثلة ستكون مصرية خالصة. من ذلك قول أحمد عرابي: “لقد ولدتنا أمهاتنا أحرارًا ولن نستعبد بعد اليوم”، وإعلان سعد زغلول بأن “الحق فوق القوة والأمة فوق الحكومة” و صكه لمصطلح “الأماني القومية”. ومنها خطب إلقاها زعماء في مصر إبان الاحتلال، ورؤساء للدولة بعد الضباط الأحرار، وفي بعضها عبارات لافتة، وإشارات ذات دلالة.
ولكل خطبة سياسية ثلاثة أبعاد، فهي نص، وخطابة، وممارسة اجتماعية، ولكل بُعد تحليله الخاص به. وفي الخطب المدروسة -على اختلاف بينها- طاقة بلاغية، وسيطرة على السياق، وإبهار بالأداء الصوتي، أو الأداء مسرحي، وتفنن بالخروج عن النص الذي برع فيه السادات مثلًا، ولا أتعجب من ذلك، فهو كاتب، وصاحب لسان فصيح، وذو تعليقات لاذعة، وله طريقة خطابية مميزة. ويتداخل علم تحليل الخطاب مع علم النفس والاجتماع والسياسة والبلاغة والفلسفة، وهذا يدل على ضرورة تمكن من يتصدى للتحليل السياسي من أسس هذه العلوم والمعارف حسبما أعتقد.
أما الكتابة السياسية فلها أربع مراحل هي: التجهيز، والكتابة، والمراجعة، والالقاء. وفي حين يرى المؤلف أن الكاتب الأساسي ينتهي عمله بعد المرحلة الثالثة، أجدُ بأن الكاتب الخبير لن يغفل عن الإلقاء، والأداء، وأجواء الخطبة، وأثرها، وسيكون له رأي فيها، وتأثير على كتابته القادمة؛ وهذه المسؤولية تتأكد في حقّ الكاتب الذي يتولى مهمة الكتابة للسياسي أكثر من مرة. وناقش مؤلفنا معضلة نسبة الأسلوب، وهل يكون للكاتب أم لملقي الخطاب؟ وخلص في النهاية إلى أن الأسلوب سوف ينسب للسياسي حتى لو جزم الباحثون والدارسون قاطبة أنه لم يكتب منه حرفًا، وهذا هو المعتاد في الكتابة السياسية.
تلك الكتابة التي تختلف مناهجها. فبعضها يحدد السياسي للكاتب أفكاره كي يتولى صياغتها، وقد يعطي السياسي لبّ الخطبة ويتكفل الكاتب بالتعبير عنها، وإقناع الآخرين بالفكرة. وربما كان كاتب السياسي واحدًا في كل مرة، أو متنوعًا حسب تخصص الخطبة وجمهورها. وربما تكونت لها لجنة للمراجعة والتصحيح، أو كتبها واحد وراجعها ثاني وهكذا. وقد يُدخل الكاتب الجرئ فيها بعض آرائه، وربما ناقش رئيسه في مضمونها أو العكس، والمتقن منهم من يستطيع إدماج عبارات في الخطبة تغدو تاريخية، وموضعًا للاقتباس والنقل، وجملًا لا تُنسى، وفيهم من يبرع في محاكاة أسلوب رئيسه حتى لكأنه من كتب الخطبة من جهد ذهنه المتفاعل مع ذاته ومسلماته وكلماته.
ومن الطبيعي جدًا أن يختار الزعيم كاتبًا يتفق معه في الفكر والمزاج. مع ذلك أورد المؤلف عدة نماذج لكتّاب امتنعوا عن الكتابة لدوافع مبدأية، أو خوفًا من ردود الفعل. وتناول بالاعتماد على سير الكتّاب حكاية “خطاب التنحي” الذي ألقاه جمال عبدالناصر، والخلاف بينه وبين كاتبه محمد حسنين هيكل في تضمين بعض العبارات، أو التنازل لشمس بدران، وهو ما لم يقو عليه قلم هيكل؛ لتحفظه على بدران، حتى وافق عبدالناصر على تغيير الاسم إلى زكريا محيي الدين.
وقد جعل أحمد بهاء الدين معظم صفحات كتابه للحديث عن تجربته في الكتابة للسادات، وفصّل في الخلاف الطويل بينهما حول مضمون عنيف أراد الرئيس إدراجه في خطبته وأبى الكاتب، حتى انتهى الأمر بينهما إلى أن ودعه الرئيس وداعًا لطيفًا لا لقاء بعده، واللطف مع ترك العقوبة منقبة بالنظر للمتوقع والمعهود. كما نقل المؤلف حيلة موسى صبري حتى ينفي عن نفسه “تهمة” كتابة خطبة نارية للسادات، وروى خبرًا عن أكاديمي كاتب اقترح على حسني مبارك فكرة فاستهجنها الرئيس قائلًا: ” كنت أعتقد أنك معنا!”، وبعدها لم يُطلب منه المشاركة الكتابية إلّا بعد عشر سنوات من مقترحه المرفوض!
وكما أن طرق إنتاج المعنى تتفاوت، فكذلك تختلف طرق الاستجابة للخطبة والاستهلاك لها، ولأجل هذه الزاوية المهمة يدعو المؤلف إلى التحول من بلاغة الخطاب إلى بلاغة الجمهور المخاطب، وصولًا إلى تأسيس بلاغة للجمهور في مقابل البلاغة المسخرة لخدمة السلطة؛ حتى يكون علم البلاغة في خدمة الطرف الأضعف، ويستطيع المتلقي بهذه البلاغة اكتشاف فجوة المصداقية، وتعرية الاستجابات المتواطئة ومنها استجابة التصفيق، وبعض التعليقات الصفيقة في أثناء الخطبة أو بعدها مباشرة، علمًا أن التعليقات ذاتها ستغدو كتابًا مفتوحًا أمام التاريخ بعد حين.
إن العلاقة بين الكاتب والسياسي مسألة تثير جدلية وستبقى بلا حسم أو قول فصل، فمن الكتّاب من جعل مهمته “الدفاع عمّا لايمكن الدفاع عنه” كما يقول “جورج أوريل” فمهما صنع السياسي فهو على حق، وبالمقابل جنح آخرون إلى المناكفة ولو أحسن الساسة غاية الإحسان، والتزم فريق ثالث دروب السلامة أو التوسط، فاللهم سلّم سلّم، ووفق الكتّاب والساسة لخير المجتمعات والبلاد، وصلاح الحاضر والمستقبل. وسيكون لي عودة إلى هذا الموضوع الحيوي والمهم بإذن الله.

المدينة النبوية- الأربعاء 08 من شهرِ رجب عام 1446
08 من شهر يناير عام 2025م