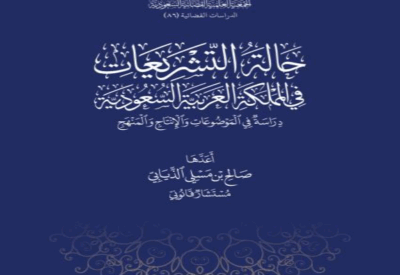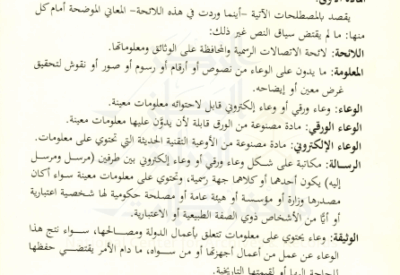مرة أخرى: لماذا تفشل القوانين؟!
بعد التفاعل مع المقال السابق عن فشل القوانين، رجعت لما جمعته من مادة بالحوار، والسماع، والقراءة، والتأمل، ورأيت مكافأة لنفسي ولمن شارك بقراءة ما سبق والتعليق عليه، أن أكتب مقالًا آخر فيه إضافات مهمة على الموضوع الذي لم أجد له -حسب بحثي- مرجعًا عربيًا، وإن علمت من عدة أساتذة جامعيين في السعودية ومصر عن قرب صدور كتاب يتناول هذا الجانب المهم، وتواصلت مع الدار الناشرة قبل أسابيع؛ فأخبروني بأنه سيكون ضمن جناحهم في معرض الرياض القادم للكتاب.
لفتت نظري أسباب وجيهة يمكن سوقها لتكون ضمن حزمة أسباب تقود لإخفاق القوانين، مع التأكيد قبل أي شيء على أن هذه الأسباب تقع في جميع بلاد العالم، وليس في دول بعينها، وإنما الاختلاف في الكثرة، وسرعة الاكتشاف، وحرية التعاطي معها. فمن الأسباب:
- غياب علم أصول القانون عن الميدان العلمي والتعليمي إن في التأليف أو التدريس أو الحجاج، وأتصور أن عالمنا الإسلامي يمكن له الإفادة من علم أصول الفقه، ومن المقدمات المنطقية لبناء علم متماسك لأصول القانون.
- ضعف العناية بالتفسير والفتيا في المجال القانوني، بعدم إسنادهما لمؤسسة معينة، أو لقلة عدد القائمين بهما، علمًا أنه يوجد مجلس للدولة في مصر يفتي، وديوان مستقل في الأردن يفسر، وقانون خاص لتفسير القوانين والنصوص العامة في السودان، ولكن المشكلة باقية.
- جهل من يفسر القانون أو يطبقه بسياق الزمان والمكان والحال المتصاحب مع إعداد التشريع وصدوره، وإن كان الأصل في التشريعات العمومية والتجريد.
- انقطاع الصلة التكاملية بين إدارات التشريع والقضاء والفقه والتعليم وذوي المصلحة، وغلبة الحرص على المغالطات وتسقط الزلل.
- جمود النصوص النظامية، ومحدودية دلالة ألفاظها، مما يعيق الإفادة الواسعة منها، ويحيج إلى التفسير والاجتهاد، وهما عرضة للصواب والخطأ.
- التقليل من شأن السوابق القضائية والنوازل الفقهية عند إعداد التشريعات أو تعديلها.
- ضعف الارتباط العضوي بين قوانين الموضوع الواحد، ولذلك اقترح عدد من أساتذة إعداد التشريعات والأنظمة وصياغتها إلى جمع قوانين الموضوع الواحد في كتاب واحد.
- غفلة واضعي القانون عن أعراف المجتمع وتجاربه السابقة، الحرص على المثالية الصارمة في بناء التشريعات مع أن الواقع ليس كاملًا.
- الانكباب إبان إعداد التشريع على القانون وحده، والانكفاء عليه اكتفاءً به، علمًا أن دراسة العلوم الاجتماعية والمالية، وفهم الثقافة المحيطة، وضرورات الأمن، وحاجات المجتمع، أمور مهمة للمنظم والقانوني والقاضي والمحامي في كل مرحلة من مراحل التشريع.
- غياب مبدأ كتابة التشريعات القابلة للتكيف مع أي مستجدات بما يجعل القانون أطول عمرًا، وأيسر في التعديل.
- تعسير فهم الالتزامات التي يأتي بها القانون والاستحقاقات والإجراءات، والقاعدة الرومانية تجزم أنه لا شيء أليق بالقوانين من الوضوح!
- بناء بعض عناصر القانون بطرق صياغة متقنة تحول دون إنشاء قانون حقيقي قابل للفهم والتحديد والتطبيق، ومن المسلّم به أن القوانين السيئة من أشد أنواع الظلم.
- طغيان الحرص على جودة الشكل والبناء على حساب جودة المضمون وعلى تحقيق الرضا المجتمعي بالقانون وقبوله.
- ضيق الأفق عن البصيرة بالمستقبل، وإغماض العين عن النتائج السيئة سواءً المحتومة أو المتوقعة أو الحادثة بعد تطبيق القانون.
- صناعة مظهر قانون وليس قانون حقيقي بوضع فجوات مقصودة في الصياغة كالغموض والتناقض والنقص والمعاني حمالة الأوجه وغيرها.
- التعقيدات التي يواجهها من يستخدم القانون عندما يصبح نافذًا.
- كثرة التجاوز والاستثناء في التطبيقات دون موجب قانوني مقنع، والأصل أن القانون كما قال “مونتسكيو”: مثل الموت لا يستثني أحدًا!
- اختلال موازين مساواة الناس أمام القانون بما يجعله قانونًا متحيزًا ومبغضًا، وهذا الخلل يكون في التنظيم، أو في التطبيق، وبوجوده يتهاوى مصطلح “سيادة القانون”.
- الخلل عند المخاطبين بالقانون في فهم القواعد القانونية المتراخية والمكملة؛ إذ الأصل اتباعها، والاستثناء جواز الاتفاق على مخالفتها.
- فقد فضيلة التعلم من الفشل بعد منقبة الاعتراف الصريح به.
- ضعف مشاركة مؤسسات حماية القانون، وقصورها عن أداء واجبها العظيم في الحفاظ عليه، وفضح محاولات التعدي والاختراق، وهذه المؤسسات متنوعة بين قضائية، وبرلمانية، وإعلامية، ومجتمعية.
- وجود فاصل زمني غير قصير بين زمن التشريع وبداية وقت النفاذ للقانون.
- تحميل مهام تطبيق القانون ومتابعته على مؤسسة حكومية واحدة مع وجود عدة شركاء فيه، وتوحيد المسؤولية قد لا يضر إذ ضمن تعاون الأطراف كافة.
- تذبذب الموقف المبدأي والفكري بين الطاعة المطلقة للقانون، والانصياع له أيًا كان -وهو مذهب أرسطو-، وبين الطاعة للقانون الصواب أو المفيد فقط؟ وينبثق سؤال هنا عمن يحدد الصواب من الخطأ؟ ثمّ هل المصلحة الفردية مقدمة على مصالح المجتمع؟ إن الانقياد التلقائي للقانون معدود ضمن الفضائل من حيث المبدأ.
- تراخي قبضة الحكومات على المجال العام مما يسهل على المخالفين العبث بالقانون، و “إن الله يزع بالسلطان، ما لا يزع بالقرآن”، وإذا أفلت من العقاب كل من تجاهل القانون فسوف تصير القوانين بلا قيمة.
- اختلاف الجواب عن مسألة مثارة خلاصتها: هل يفرض القانون بالقوة أم يسبق إصدار القانون باستعمال وسائل ناعمة للإقناع به، وتقريب المجتمع من فهمه ومعرفته.
- طبيعة الانسان التي جبلت على التمرد وحب التفلت والعصيان.
- شيوع مفاهيم خاطئة تصف الملتزم بالقانون بأنه جبان قليل الحيلة، وتخلع على المتمرد أوصاف الذكاء والقوة والتمكن. إن انتشار هذه القناعة في أي مجتمع نذير شؤم قانوني.
- هشاشة البرامج التربوية التى تعنى بتوقير القوانين، وضرورة الامتثال له، وتطبيق نصوصه، مع إمكانية إصلاحه وتعديله لأنه صناعة بشرية غير معصومة.
- الاحتلال التشريعي مثلما أسماه الفقيه القانوني د.عبدالرزاق السنهوري -رحمه الله-، وهذا الاحتلال إما أن يكون احتلالًا عسكريًا واضحًا، أو احتلالًا فكريًا بالتبعية والتقليد، وشيمة المجتمعات العريقة رفض أي قانون غريب عليها، وليس من نسيجها.
إن معرفة الشر تجعل الإنسان والمجتمع أجدر ألّا يقعوا فيه، وهذا أحد أهم الأسباب الدافعة لكتابة هذين المقالين وما قد يتبعهما. إن التجويد والإتقان في وضع القوانين يتطلب من الجهد الكثير الكثير، وهذا التعب والكدّ الذهني والجسدي والمالي يستلزم المقابلة بالتقدير والامتثال من الكافة دون الامتناع عن النقاش والنقد الهادئ المبني على برهان من علم أو تجربة، وتظافر هذين الأمرين يسوقان المجتمع والمجتمع القانوني والعدلي بالأخص إلى مرتبة من السمو والرقي المعنوي والمادي يغبط عليها أهلها، ويكونوا بها لغيرهم قدوة.
أحمد بن عبدالمحسن العسَّاف-الرياض
الاثنين 08 من شهرِ صفر عام 1446
12 من شهر أغسطس عام 2024م